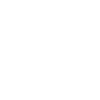سرّ فلسفة الفاعلية الوجودية: كيف تتجلى القوة الإلهية في الفعل الكامل؟| بقلم الباحث و المفكر فادي سيدو | مجلة رصيف 81 الثقافية

يقول العبد الفقير لله ...
الفعلُ هو انعكاسُ العقلِ على العالمِ... فادي سيدو
يقول تعالى في كتابه العزيز: "الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيراً".
ويقول سيدنا المسيح "ع": "لست أفعل شيئاً من نفسي بل أتكلم بهذا كما علَّمني أبي".
اعلم أيها المؤمن أن الفاعليَّة الوجوديَّة تمثل جوهر الحياة وعمق المعنى في الوجود البشري. فهي مصدر الحركة والتغيير والتجدد المستمر، التي تفتح للإنسان أبواب الفهم والإلهام والاكتشاف. في هذا السياق، يُعتبر المُبّدي عَظيماً في قدرته على خلق الفعل الكامل، الذي يعبر عن ذاته في سياق الوجود وتفاعلاته.
هذا الفعل الكامل لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تفاعل دائم بين الفعل العاقل والفعل المعقول، حيث يكمّل كل منهما الآخر في انسجام متناغم. بهذه الطريقة، يتحقق الكمال الوجودي وتظهر معالم الجلال والتفرد في كل ما نقوم به من أفعال. إن الفهم العميق لهذه الفاعلية يجعل منها ميداناً مترامي الأطراف، حيث ترتسم معالم الفكر والتصميم والإرادة، وتوضع قواعد السلوك الرفيع والمعرفة الواعية التي تعود في النهاية إلى الأصل الأسمى الذي أبدعها ووجّهها.

في سياق التصور الوجودي للعوالم المعنوية، يتجلى مفهوم الفعل في إطار كيان يحمل أبعادًا وجودية ومعرفية متعددة. يبدأ الأمر بتكريم صاحب مقام الفاعلية لفعلِهِ الكامل، وهو ذلك الفعل الذي تتمثل فيه طبيعة المصير المحتوم والمسارات الراقية، حيث أوكل إليه مهمة الإيجاد والخلق. من خلال هذا التفويض المهيب، تكونت أولى الخطوات في عالم الفعل ألا و هي إيجاد الفعل العقلي، الذي انبثق من جلال الفعل المعقول بأفقٍ صائب وحكمةٍ متناهية. تعقب هذه السيرورة الكلية الأفعال الأخرى، التي تتكامل لتشكل لوحة واسعة من الأفعال الكلية التي يحكمها العدل والتوازن.
يتبع هذه الحركة بتجلي مصدر هذا الفعل الكامل أمامه، مما يسمح له بمشاهدته على هيئته الكاملة، فيتأكد ويكمل التسبيح والتنزيه. ومن هنا، فإن الفعل الكامل، في جوهره، يصبح أول من يعاين مقام الفاعلية الوجودية، الذي يعقبه الفعل العقلي والأفعال الأخرى، ليبدأ مسلسلًا من التفاعل والتماثل الذي ينبني على أسس معرفية ووجودية راسخة.
يُبيِّن العديد من العلماء والمفكرين والمفسرين من أُمَّة التوحيد أن الله تعالى عبَّر عن قدرته الخلَّاقة التي تتجاوز حدود الفكر البشري.
حيث يُعتبر مفهوم الفعل الكامل وارتباطه بالفاعل الأسمى من الركائز الأساسية في الفلسفة والتوحيد، حيث يُنظر إلى الله على أنه المبدع الأوحد الذي يخلق الأشياء دون اعتماد على مواد خام أو أجزاء سابقة.
يستند هذا الموقف إلى الفهم القرآني للخلق، حين قال "بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ"، أكَّد على مُطلق الفاعلية والإبداع دون حاجة إلى مادةٍ أو نموذجٍ مُسبق.

يُفسِّر فهم الإمام علي بأن الأشياء وُجدت "لا من شيء"، كمبدأٍ يُحكم على من يُحاول أن يُجزِّئ أو يُشبِّه هذه القدرة الإلهية بأنه أوقع نفسه في الشرك. الأمر ليس كعمليةٍ جزئية تعتمد على شيءٍ مُسبق، بل هي إبداعٌ بحضرة الأمر الإلهي المحض "كُنْ فَيَكُونُ"، الذي يُشير إلى هيمنةٍ وسُلطةٍ مُطلقة خالية من كل نقص أو تبعيض، تتوافق مع أسس التوحيد الطاهرة التي تغيب عنها التصورات المادية والقوالب الفكرية المحدودة.
في هذا السياق، يُؤكد استخدام كلمة "من" لتكون دالة على الفاعلية وليس التجزئة، مما يُعزِّز الفهم الصحيح دون الإيحاء بأي نوع من التشبيه الذي قد يعكر صفو العقيدة التوحيدية.
وحتى في إطار الفلسفة كما لدى أرسطو، يأتي التوكيد على جوهر الفاعلية بعيدًا عن أي تصورات تجزيئية مبتذلة أو تلك التي تدعو إلى الاتحاد والاندماج الكلي، وهو غير مقبول في مدار العلوم الإسلامية الراسخة، حيث يُظهِر مدى التباين بين الخالق والمخلوق، مما يحفظ لله وحده عظمة الإبداع وكمال القدرة والإلهامية.

إنَّ الفاعليَّةَ الوجوديَّةَ تتجلى في الجمع بين عالَمَي العقلِ والحسِّ حيث يرى الناظرُ في كُلٍّ مِنْهُمَا أمر الفاعلية الإلهية، كما وصفها القرآنُ الكريم في قوله: "أَفِي اللهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ". هنا، يتضح أنَّ "فاطر" السماوات والأرض ليس فقط الخالق، بل الذي تَظهرُ فاعليَّتُه في كلٍّ من عالم العقل والحسِّ. وتلكَ الفاعليَّة تُبرزُ الفعلَ أوّلًا وتحدد الفاعل ثانيًا، حيث يُظهِرُ الفعلُ كنهَ الفاعلِ. إنَّ الذي يَصِفُ مقامَ الفاعليَّةِ يُدرِكُ أنَّ الجوهرَ قد تجرَّدَ عن حدود الفعلِ والسِماتِ، ورُغم ذلك يُطلقُ عليه ألقاب الفاعليَّة عندما يُظْهِرُ فعلَه. هذا التجردُ والجمعُ بين الفَوَاعِل يؤسِّسان لمكانةٍ تفوق تصوُّرَنا البشري للفعل والفاعل كما تعارفنا عليه لغويًا ووجوديًا، حيث تَرِدُ الأفعالُ أوّلًا في تراكيب الجمل في اللغة العربيّة، ليُحدِّدَ ذلك المجالَ الذي تُبصرُه العقول وتلمسُه الحواسّ.
بالحديث عن مسألة الفعل والعلاقة بين الجوهر والفعل، يظهر أن العديد من الفلاسفة والمتكلّمين قد اندفعوا إلى زعم خاطئ يتعلق بمفهوم الفاعلية. إن جعل الفعل جوهرًا للفاعل يؤدي إلى إشكالية لاهوتية وفلسفية، حيث يُفضي إلى نوع من الشرك بافتراض وجود مساوٍ لله في أفعاله. يكون هذا واضحاً في سياق الرواية التي تؤكد موقف الإمام علي الرضا "ع"، عندما طُرح عليه سؤالًا يتعلق بموقف بعض الأفراد الذين يعتقدون أن الله قديم بعلم وقدرة وسمع وبصر كصفات منفصلة عن ذاته. جاءت الإجابة لتضع حدًا لهذه الفرضية، مؤكدة رفض فكرة تعدد الآلهة، حيث إن اعتبار أي صفة أو فعل مستقل بذاته هو مشاركة في الإلهية والشرك بالله. يوحي هذا الطرح بأن صفات الله ليست كيانات خارجية منفصلة بل هي جزء من كينونته، مما يرفع عنه أي تشبيه أو تساوي مع الخلق.

يُعتبر الخَلْقُ بمثابة انعكاسٍ لقدرةِ الفاعلِ ومهارته، حيث إن النجار، بمهارته العالية وذهنه الحاذق، يُحول قطع الأخشاب الجامدة إلى كائناتٍ مادية ذات فائدة وجمال، كتلك الكراسي التي جلبت الراحة وجسدت معالم الفكرة الأصلية للعقل البشري. لكن رغم جمالِها واكتمالها، لا يمكن اعتبار الكراسي أكثر من تجسيد لتلك المهارة والإبداع، فهي تبقى مجردةً عن جوهر النجار ذاته؛ وإنما تعكس جزءًا من إبداعه. وعلى هذا الأساس، يشير الحكيم إلى ضرورة العلاقة بين الخلق والخالق، وهي علاقة دلالية أكثر منها جوهرية. إن الأفعال والمصنوعات، مهما بلغت من الجمال والكمال، يجب أن تُعتبر طُرقًا للتفكر والتأمل في قدرات الخالق، وليست بأهداف في ذاتها. ونرى في تعاليم الإسلام الحث الدائم على تجاوز المظاهر والشكل الخارجي للأشياء للدخول في جوهر التفكير العميق حول الفعل الإلهي في الكون، والتدبر في الأسماء والصفات دون فصلها عن الذات الإلهية. ويعزز هذا الفهم قول النبي محمد "ص": "الشرك في أمتي أخفى من دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على المسح الأسود"، حيث يتم تذكير المؤمن الموحد بالتجاوز عن الظواهر والالتزام بعلاقةٍ مباشرةٍ وواضحة مع الله بعيدًا عن أشكال الشرك الخفية.
في مناقشة فلسفية عميقة حول طبيعة الأفعال والفاعلية، تثار الأسئلة حول ما إذا كانت الأفعال مجرد إضافات إلى جوهر مقام الفاعلية. إذا افترض البعض أن الأفعال زائدة، فإن ذلك يشكل نوعًا من الشرك، حيث يصبح الفعل مغايرًا لذاته ومفصولاً عن الفاعلية. في المقابل، إذا تم التعاطي مع الأفعال باعتبارها الجوهر عينه، فستدخل المسألة في تعقيدات من حيث العبادة والدور الذي يلعبه الفعل. في علم الحكمة، لا يجوز تقديم العبادة للفعل بحد ذاته، بل يجب النظر إليه كوسيلة أو طريق نحو فهم أعمق، وليس كغاية نهائية. من هنا، يصبح من الأهمية بمكان إدراك أن الفعل مهما كان، يبقى محدودًا وداخلًا ضمن نطاق الحروف والإحاطة اللغوية، كما يشير النص القرآني إلى الأسماء التي انصاغت من دون سند إلهي "إِنْ هِيَ إِلاَّ أَسْمَاء سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ". هذه النظرة تدعو للتفكير في الفعل ضمن سياق أوسع، حيث يكون جزءًا من مسيرة الفهم والتجربة الإنسانية الشاملة.
تتناولُ هذه المسألةُ الفلسفيَّةُ المعقَّدةُ مفهومَ الواحديَّة في الذَّاتِ وضبطَ صفاتِ الفاعليَّةِ بحيث لا تُفضي إلى تعدُّدٍ يُنافي التَّوحيدَ. إذا ما قيلَ بأنَّ الأفعالَ والصفاتَ تُضافُ إلى جوهرِ مقامِ الفاعليَّةِ، فإنّ هذا يُفضي إلى إثباتِ العددِ والكثرةِ في ما يجبُ أن يكونَ واحدًا وجامعًا من جميعِ الوجوهِ. والعقلُ يحتارُ هنا: كيف يُمكنُ للواحدِ الأحدِ أن يتجزَّأَ إلى عناصرَ متعدِّدةٍ؟ فإنْ جرُّنا القولُ إلى عدمِ إثباتِ الأفعالِ المضافةِ إلى الجوهرِ، فسنقفُ أمامَ معضلةٍ أعمقَ تتجلَّى في اعتبارِ مقامِ الفاعليَّةِ كاملاً في ذاتِهِ دونَ نقصانٍ، والإشكالُ يتفاقمُ إذا نظرنا أنَّ كلّ ما هو كاملٌ في ذاتِهِ بدونِ إضافَةِ عنصرٍ خارجي، يكونُ ناقصًا بطبيعتِهِ الداخليَّةِ، وهذا يتعارضُ بشكلٍ جذريٍّ مع ضرورةِ الكمالِ المطلقِ. إذاً، كيفَ يُمكننا التوفيقُ بين وَحدةِ مقامِ الذاتِ وكمالِها الذاتيِّ دون التورُّطِ في تناقضاتٍ تتعلَّق بالعددِ والنقصِ؟

في محاولة لفهم عميق لمعنى الفعل والفاعلية، نجد أن مسألة نفي الأفعال تقودنا إلى التفكير في مفهوم الكمال والنقص. الإدراك العقلي المجرد يسعى إلى التجريد الكامل للذات عن الأفعال، لأن إثبات الفاعلية قبل وجود الأفعال يمثل معضلة منطقية. إن قول أرسطو طاليس بأن "القوة الواحدة يمكن أن تكون قابلة للأضداد جميعاً" يشير إلى تعقيد مفهوم الإمكان والقدرة باعتبارهما ليسا سوى جزء من الإطار الأشمل لفهم الفاعلية. المعرفة التي تعتمد فقط على الإدراك الحسي والوجود هي معرفة ناقصة في غياب التجريد العقلي الذي يفصل الذات عن الأفعال.تُعتبر المعرفة القائمة على الإثبات والإدراك للوجود مرحلةً أولية، إلا أنها تبقى غير مكتملة إن لم تصعد إلى مستوى التجريد. فالتجريد يعني تخليص الفكرة من جميع الأفعال الخاصة بها، خاصةً وأن افتراض أن هناك فعلاً قائماً قبل حدوث الخلق يتنافى مع المنطق، إذ من المحال أن يكون هناك فعلٌ مُنجزٌ في الأزل. إن عملية التجريد تضفي على الفهم عمقاً إضافياً، تسمح للعقل بأن يتجاوز التصورات البسيطة ويتبنى منظوراً أعمق وأكثر شمولية للإدراك. وبدون هذا الجمع بين الإثبات والتجريد، يبقى القلب قلقاً وغير مطمئن، فمن خلال الفهم المزدوج لكل من التفاصيل الدقيقة ونظرياتها المجردة، تستطيع العقول أن تبني براهينها بأسس منطقية راسخة، مما يمنحها القدرة على مواجهة التساؤلات والتحديات.في النهاية، يحقق القلب الاطمئنان عبر التوازن بين الإثبات والتجريد، ويجعل من الفهم الفلسفي للعقول وطبيعة البراهين وسيلة لسبر أغوار الوجود بعمق أكبر.
و كما أقول دائماً و أبداً:إنَّما الفعلُ يكونُ طريقًا نحوَ الهدفِ وليسَ هو الهدفُ بحدِّ ذاته... فادي سيدو
الوكالة الإعلامية الألمانية Sirius Media
_مجلة رصيف 81 الثقافية الألمانية
شيرين بكر حمو
الرصيف الصوفي التوحيدي